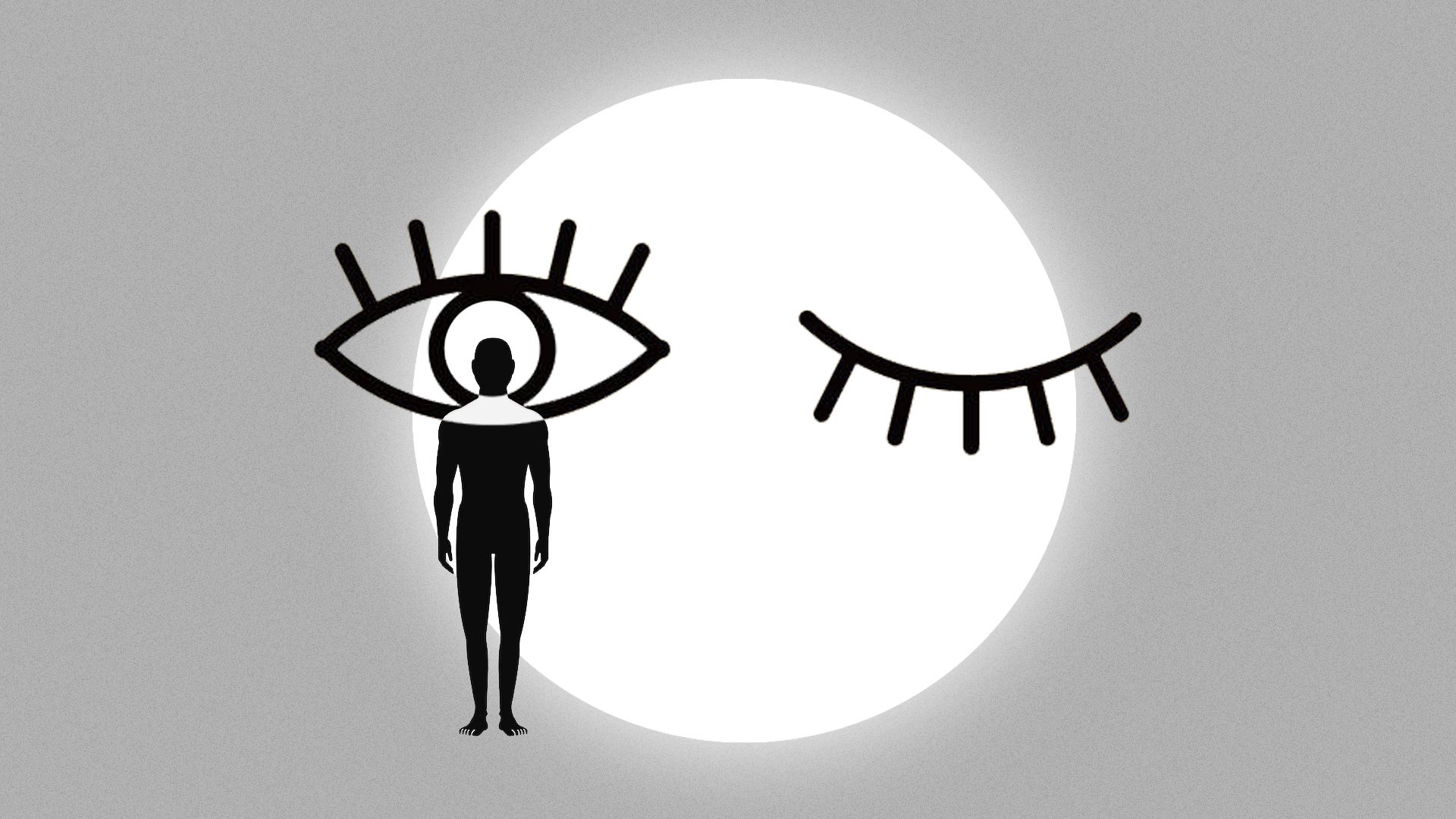كيف تقول لطفل في الثامنة إنّك ستفقد بصرك؟ بأي كلمات ستشرح إنك بعد اليوم لن ترى لعبتك المفضلة أو كارتونك الأحب لقلبك؟ كيف تجعله يفهم أن خلايا شبكية عينه آخذة بالتلف والتوقف عن وظيفتها، وهو ما سيؤدي يوماً ما وبنسبة كبيرة إلى إغراقه في الظلام؟ الظلام الذي يخافه جميع الأطفال، ظلام من صنع جسدك ولا قدرة لك على الخروج والنجاة منه.
في الثامنة تقريباً من عمري، كنت ألعب وأصدقائي أمام البيت وفي المدرسة، وكنت أخفي هذا السر الذي على الأرجح لم يكن ليفهمه الصبية أقراني، حتى لو حاولت شرحه لهم؛ وفي حياة أخرى ربما في ذات موقفهم لن أكون مختلفاً عنهم.
“نص عين”
بين عام 1999 و2000 شُخِّصتُ باحتمالية الإصابة بسرطان العين، وهو ما لم يترك خياراً للأطباء وعائلتي سوى قلع العين اليسرى، وقاية من شر ما يختبئ في داخلها، فهذا النوع من الأورام قد يتلف الرأس كله وينهي حياة المصاب بسرعة.
بعد قلع عيني ومع الفحص المختبري تبين إنه لم يكن ورماً خبيثاً، بل التهاب الشبكية الصباغي، وهو مصطلح لحالة طبية كناية عن عيب في المورثات التي تساعد خلايا شبكية العين على أداء وظيفتها، وبسبب هذا العيب تبدأ وظيفة شبكية العين بالتدهور وبالتالي تتراجع القدرة البصرية للمريض. ومع تقدم المرض، قد تبدأ الرؤية المحيطية تتدهور، وكل الأشياء التي تقع في أطراف المجال البصري تبدأ أن تكون مظلمة، حتى وصول المصاب لما يعرف بالرؤية النفقية: فقدان كامل للرؤية المحيطية. وفي المرحلة النهائية يفقد المصاب رؤيته المركزية، أي فقدان بصره بالكامل.
تختلف أعراض وتأثيرات هذا المرض بشكل كبير بين شخص وآخر، فلكل حالة ظروف تحدد سير الأعراض ودرجة تقدم المرض وما إذا كان المريض سيفقد بصره جزئياً أو سيفقده بشكل كامل.
عادة ما تبدأ الأعراض الأولى في سن الطفولة أو الشباب ولم أكن استثناء من هذه القاعدة، في الحقيقة لم تنتظر هذه المشكلة في عيني حتى إكمال عامي الأول قبل أن تظهر كتغير غريب في لون العين اليسرى، لاحظته أمي في أول أربعة أشهر لولادتي.
وعلى الرغم من الرؤية الجيدة نسبياً التي كنت أتمتع بها في طفولتي المبكرة بين السابعة والحادية عشر، لم يكن التعايش مع “نص عين” بالأمر السهل، فاليسرى مقلوعة واليمنى رؤيتها جزئية، وكانت هناك، دائماً، حدوداً لا أستطيع تجاوزها وإلا فسأكون عرضة للإصابة والحوادث.
كان بصري يُمكننّي من الرؤية لمدى يبلغ المترين، ويجعلني اشترك في لعب كرة القدم وركوب الدراجة الهوائية خلال النهار، لكن مع تلاشي ضوء الشمس تتلاشى جودة بصري بدرجة تعيق أنشطتي الرياضية.
مجبراً أمتنعتُ عن الألعاب ليلاً، وفي بعض المرات التي تخليت فيها عن حذري انتهى بي الأمر مَرمي على الأرض، فوق أو تحت أو بجانب الدراجة الهوائية مغطى بالتراب والكدمات وأحياناً بعض الدم، بسبب عائق لم ترصده “نص عيني” في الوقت المناسب.
اللعب، بطبيعة الحال، لم يساعدني على الكتابة والقراءة.
“التعلم باللمس”
المشكلة الأكبر التي يواجهها جميع فاقدي البصر في العراق هي الحصول على فرصة التعليم، نتيجة نقص المدارس المخصصة للمكفوفين والمعلمين المدربين للتعامل مع الطلاب المكفوفين وتلبية احتياجاتهم، ناهيك عن عدم توفر البرامج والتقنيات التي تسهل الوصول للمناهج الدراسية.
ومع افتقار العراق لجميع هذه المتطلبات، فأي مكفوف يريد الدراسة لن يكون لديه أي خيار سوى الالتحاق بمدرسة عادية -كما حصل معي- لا تملك أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع الطلاب المكفوفين ومتطلباتهم التعليمية.
عندما حاولت التسجيل في المدرسة أول مرة، رفضت إدارة المدرسة قبولي. فرغم مقدرتي على الرؤية الجزئية، لكن بصري لم يكن قوياً لأستطيع القراءة والكتابة باستقلالية، وتطلب الأمر كتاباً خاصاً من مديرية التربية في الناصرية موجهاً لإدارة المدرسة ليقبلوني كطالب..
ومع عدم وجود وسائل التعليم الخاصة بفاقدي البصر في المدرسة، فُرِضَ علّي وعلى أمي التي كانت حريصة على تعليمي، أتباع نهجاً خاصاً لأستطيع اكمال مسيرتي التعليمية.
في الصف الأول، ومع أول “دار دور” بدأت التحديات: فكيف أتعلم الحروف الأبجدية وأنا لا أقرأ ولا أكتب بمفردي؟ كيف ستجعل أمي من إبنها -شبه المكفوف- أن يتمكن من القراءة والكتابة؟

هنا تفتق عقلها لتبتكر حلاً بسيطاً لدرجة الابداع رغم إمكانياتها الشحيحة. استخدمت قطعة كبيرة من “الكارتون” ثم قطعته بعناية لأشكال تحاكي الحروف العربية بحجم كبير بما يكفي لأراها وألمسها وأردد ورائها اسم الحرف، وبهذه الطريقة تعلمت الحروف الأبجدية العربية، إذ حرصت والدتي على متابعة هذه الطريقة في المرحلتين الأوليتين للدراسة، أما في باقي موادي الدراسية، فكانت تلقي على مسمعي المعلومات وأكررها بعدها لأحفظها.
ومع تقدمي في المراحل الدراسية، كان علينا تجديد وابتكار أساليب بما يتناسب والمواد الدراسية الجديدة.
في البداية، أستغرب زملائي من التلميذ صاحب “النص عين”، لكن مع مرور الأيام تعاونوا لمساعدتي في الحالات الطارئة مثل الأيام التي مرضت بها واستلزمت عودتي للبيت. الإدارة كانت تسمح لهم بمرافقتي للمنزل ثم العودة للدراسة، أما المعلمين الذين كنت في عهدتهم، فرغم كونهم غير مدربين للتعامل مع الطلاب المكفوفين، إلا أنهم قدموا كل أشكال الدعم الممكنة.
كان معلم كل مادة يأخذ كتابي عند نهاية حصته اليومية ليضع اشارات للدلالة على الدرس الذي يتوجب عليّ تحضيره في البيت، ولولا هذه المساعدة لتكرر ما عشته في إحدى حصص مادة اللغة الانجليزية.
في العراق -أو على الأقل في المدرسة التي كنت أرتادها- عندما يجلس التلاميذ في مقدمة الفصل، فهذا يعني أنهم من بين الأفضل بين أقرانهم. وعندما يبدأ المعلم بالبحث بشرح الدرس شفهياً أمام الشعبة، فعلى التلاميذ ان يتنافسوا بشراسة من خلال الوقوف ورفع إحدى اليدين والهتاف بصوت مرتفع “استاذ” وتكرارها بشكل سريع ومتلاحق فتتحول الكلمة إلى “ستاذ ستاذ ستاذ”، محاولين انتزاع الحق في إلقاء معلومات الدرس الذي سهر بعضهم الليل لدراسته، وبالتالي الحصول على درجة كاملة في التقدير اليومي.
لكن ماذا سيحدث عندما تجتمع الظروف بشكل غادر ضدك؟ كنسيان بسيط يرافقه حظ عاثر؟ ستكون “غلطة الشاطر بألف”، كما يقال.
في ذلك اليوم المشؤوم، نسيت “تأشير” درس اليوم التالي وفشلت في محاولة الاستدلال عليه في البيت، فكانت النتيجة إنني ذهبت للمدرسة دون تحضير مادة اللغة الانجليزية، ومن بين جميع الأيام شاء القدر أن تأتي مشرفة اللغة الانجليزية إلى المدرسة لمراقبة سير التعليم فيها.
ولأني طالب المقعد الأول -“السجاج”- وقع اختيارها علي، لكن عندما طلبت مني المعلمة ترجمة كلمة Swim التزمت الصمت، وحين طلبت تهجئتها فشلت، ولم أقدر على وضعها في جملة مفيدة كما طلبت.
أن تكون من أفضل طلاب المدرسة وتحسن صنعاً في جميع الأيام، باستثناء اليوم الذي تقف فيه أمام الزملاء والمشرف التربوي ومعلم المادة الذي وضع ثقته فيك لكي تبرهن للمشرف التربوي أنك نموذج لجودة تدريسه؛ حينها، ستغمرك مشاعر من الحنق والخزي المطلق وإنك خذلت من وثقوا بك.
كانت تلك اللحظات اسوأ ذكرى طوال مسيرتي الدراسية، ومنذ ذلك اليوم بقيت هذه الكلمة ذات الحروف الإنكليزية الأربعة محفورة في عقلي Swim، وتعني السباحة.
بعد تلك الواقعة صرت حريصاً على تأشير وتحضير واجباتي الدراسية دون تهاون، وأحياناً كنت اتأخر لما بعد انتهاء الدوام الرسمي ليقوم أحد زملائي بتأشير المطلوب لليوم الدراسي التالي. وفي اليوم الذي لا احفظ فيه المادة المطلوبة لأي سبب، كنت حريصاً على إخبار المعلم فور دخوله، “آنا ما قاري لا تگومني”. وكان الاساتذة يتفهمون ويتقبلون مغزى ما أقوله، فجميعهم يدركون إنني أخوض كفاحاً يومياً بمساعدة أمي لمواكبة الدروس، وفي مرات عديدة عندما يكون الجدول مزدحماً على سبيل المثال، “خمس تحاضير والسادس امتحان شهري”، كنت أجبر على تجاهل قراءة أحد الواجبات بسبب ضيق الوقت.
سبع مراحل
مع تقدم مسيرتي ووصولي للصفوف التي تتطلب إمتحانات تحريرية شهرية ونصف سنوية وسنوية، أي الصف الرابع وما يليه، تطوع العديد من الأساتذة لمساعدتي.
كنت أقصد غرفة المعلمين أو المدير في بعض الأحيان حاملاً ورقة الأسئلة ودفتر الامتحان، فيبادر أحد المدرسين ممن ليس لديه حصة، للكتابة بدلاً عني، فيطرح الأسئلة الامتحانية وأمنحه أجوبة شفهية ليقوم بدوره بكتابتها في الدفتر الامتحاني. وبالطريقة عينها خضتُ امتحان البكالوريا للصف السادس الابتدائي، مع فارق إن الاستاذ الذي كان يكتب بالنيابة عني كان مختار خصيصاً من الوزارة لهذه الغاية وليس من المدرسة التي أرتادها.
وهكذا، توالت سبع مراحل دراسية بـ”نص عين”، وبعد اصابتي بالتهاب القرنية عام 2011، صرتُ متأكداً من قدوم يوم محتوم سأفقد فيه القدرة على الرؤية، إذ قصر مدى الرؤية من مترين إلى 30 سم.
في العطلة الصيفية لعام 2014، وبينما العالم منشغل بالإحداث السياسية، كنت قد فقدت بصري بشكل كامل، وبهذا بات ذهابي إلى المدرسة بمفردي أمراً مستحيلاً، فسابقاً كنتُ احتاج أحد فقط في فترة الدوام المسائي، لكن الآن صرت بحاجة لِمن يصحبني إليها ومن يعيدني إلى البيت، لغياب الطريق الخاص بالمكفوفين.
الشارع لم يكن مُعبداً في الأصل، والحفر و”الطسات” تعيق المبصرين فكيف بغيرهم؟
ولأن الظروف المعاكسة لما نريد كثيراً ما تأتي معاً وليس ظرفاً واحداً، “كلهن إلتمن”، فشقيقي الأصغر وصل لمرحلة السادس ابتدائي “بكالوريا” أيضاً، ومع إبنين في مرحلة مفصلية في المدرسة إستحال على أمي أن تتابع تدريس كلينا، فكان لا بد لأحدنا أن يوقف مشواره المدرسي. وهكذا طلبت مني ترك المدرسة.
لم أتعرض لأي ضغط أو اجبار مباشر، لقد أوقفت مسيرتي التعليمية بكامل إرادتي حرصاً على عدم ضياع مستقبل شقيقي المبصر.
آنذاك وفي تلك اللحظات، كان الشعور قاس على طفل، إذ اختلطت عليّ مشاعر واجب التضحية لأخي المبصر بعينين، وما بين ألم شعور مفارقة أحلامي.
لا أذكر بالضبط تلك المشاعر المختلطة التي أتخمت غصة في حلقي، وتعود كل ما ذكر أسم التعلم، لكنني أتذكر شيئاً واحداً فقط وهو حتى بعد مرور عشرة أعوام، ما زالت الذكرى مفعمة بالألم والمرارة وحتى الندم. ليس مرارة فقدان البصر، إذ كنت أعلم إنني سأفقده ولم أبال كثيراً، بل توقف رحلتي المدرسية وما جلبه من عزلة خانقة بغياب الأنترنت ووسائل التواصل الحديثة آنذاك، واستقلالية المقدرة على الخروج من المنزل والعودة إليه.
كانت المدرسة المنفذ الوحيد لأشعر بالعالم الخارجي، لكن بفعل الظروف، مجبراً، افترقتُ عن القلم والكتاب، نافذتي الأوحد.
لكن من قال إن الحكاية انتهت؟
وسط تلك الأيام التي غلفها الظلام، قطعت عهداً على نفسي، أن أعود للدراسة مع أول فرصة سانحة، وسأستعيد الأصدقاء القدامى: الكتاب والدفتر والقلم، وسأصبح طالباً جامعياً، وانتهزت كل فرصة في الانترنت لاستمع لكتب صوتية ومقالات وانغمس بنقاشات بفضل خاصية قارئ الشاشة “الناطق” في جهازي نوع “الآيفون”.
وبعد 10 أعوام على تركها، عدتُ لمحاولة الدراسة من جديد، وحصلت على المناهج بالصيغة التي أحتاجها كمكفوف، صيغة “word”، التي يمكن لخاصية “الناطق” التعامل معها وأردد ورائه للحفظ، كما كانت والدتي تفعل.
وبانقضاء كل هذا الوقت، لم يتغير الحال كثيراً عما كان عليه وضع تعليم المكفوفين في السابق، فحتى اللحظة تغيب مدرسة متوسطة وإعدادية حكومية للمكفوفين في الناصرية حيث أعيش، لكن بإصرار جديد لأثبت ذاتي أكثر، سأستمر بمحاولة خوض الامتحان “الخارجي” بموارد اكتشفتها وطوعتها لنفسي كصديقي “الناطق”، لأجل ذاك الطفل بتك عين، ليبصر بالتعلم وليس بالعين.